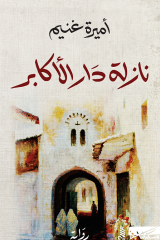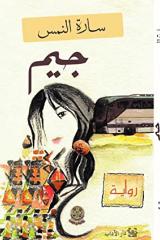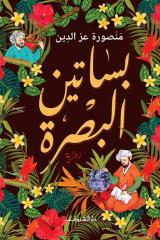حوار مع محمد عبد النبي المرشح في القائمة القصيرة
06/04/2017

أين كنت عند الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية؟ وماذا كان رد فعلك؟
كنتُ كالعادة في بيتي، وشعرتُ بفرح كبير طبعًا.
ماذا يعنى لك ترشيح روايتك فى القائمة القصيرة للجائزة؟
هو أقرب إلى معجزة صغيرة، كما أنه يضع مسؤولية كبيرة على عاتقي أتمنى أن أستطيع تحمّلها.
الرواية مكتوبة من وجهة نظر هانى محفوظ كلية، والرجال في الرواية إما مثليون أو معادون للمثليين. ألا يوجد رجال غير مثليين ومتفهمين للمثلية؟ على سبيل المثال لقيت روايتك دعما من الكثير من الرجال.
هناك بالطبع غير مثليين ومتفهمين للمثلية، في الحياة وفي الرواية أيضًا هناك على سبيل المثال الطبيب النفسي سميح الذي كان يساعد هاني محفوظ على اجتياز محنته، ولو لم يتم التركيز عليه فذلك لأسباب فنية خالصة، ولأن وجهة نظره – المتهفمة والتقدمية – يفترض أن تكون متوقعة ومعروفة وكنت أحاول الابتعاد عن الرسائل الخطابية المباشرة قدر الإمكان.
قلت فى حوار سابق إنك خلال عملية كتابة هذه الرواية تراجعت عن المشروع أكثر من مرة. لماذا؟
لم يكن تراجعًا، الفكرة نبتت كقصة ثم وضعتها جانبًا فترة طويلة وانشغلت بمشاريع أخرى، ثم رجعت إليها وطوّرت حكايتها تدريجيًا، وفي الأثناء قد أكون توقفت أكثر من مرة نظرًا لانشغالات عملية أخرى لا أكثر.
ما هى الكتب التى تقرأها الآن؟ ومن هم الكتاب الذين أثروا فيك كروائي؟
أقرأ الآن – بالتوازي تقريبًا - كتابين عن الأمومة وأسرارها وأشباحها وأساطيرها من وجهة نظر كاتبات عربيات، الأوّل هو ديوان الأمومة، وهو نصوص وشهادات عن الكتابة والأمومة لمجموعة من الكاتبات المصريات والعربيات قامت بإعداده الشاعرة رنا التونسي، والثاني هو كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها، للشاعرة المصرية إيمان مرسال. وأظن أنها منطقة كتابة ما زالت مجهولة وتحتاج لمساهمات وإضافات أخرى كثيرة.
الكتاب الذين أثروا فيّ كروائي أكثر من أن أحصرهم في قائمة، منهم مصريون وعرب وغير عرب، ومن أجيال مختلفة ومدارس مختلفة، كما أنهم يتغيرون باستمرار وتتغير درجة تأثيرهم لذلك سيكون من التسرع والظلم أن أقتصر على اسم أو اسمين.

اقرأ مقتطفا من رواية "في غرفة العنكبوت" هنا:
كلّما تقدمتُ في الكتابة تتسع هذه الغرفة الصغيرة، وتتراجع جدرانها مبتعدة حتى تختفي تمامًا، وتبقى صفحات الدفتر أمامي هي المكان الوحيد الحاضر. أراوغُ، فآخذ الذاكرة لأبعد ما يمكنها الوصول إليه، تأجيلًا للمواجهة. أشعر كأنني أودّع حياتي بتكفينها في سطورٍ وكلمات. لم أقترب من الجروح المفتوحة بعد، ما زلتُ ألف وأدور على الورق، تمامًا كما أسيرُ مُضيّعًا جسدي في زحام وسط المدينة كل ليلة.
قبل يومين، خرجتُ في جولتي المسائية فاكتشفتُ أنني نسيتُ نظارتي السوداء وخرجتُ مكشوفَ الوجه. رفعتُ يدي اليمنى لكي أضبط وضعها على عينيَّ ففوجئتُ بأنها ليست هناك. شعرتُ وكأنني نزلتُ إلى الطريق عاريًا لا يسترني شيء. لم أكن قد ابتعدتُ إلَّا بضع خطوات عن باب العمارة التي يشغل الفندق طوابقها الثلاثة العليا. نظرتُ حولي بسرعة، على سبيل الاطمئنان، لم أجد ما يُريب، ومع هذا فقد وجدتني أرتعش، على الأقل أصابع يديّ كانت ترتعش بوضوح. تظاهرتُ بأن كل شيء عادي، محتاطًا لمراقبةٍ ما، كأنّ عيناً كبيرة واسعة، مفتوحة ليل نهار، ترصد أدقّ تحركاتي، وربما خواطري أيضًا. لستُ وحدي، ولم أُشفَ بعد.